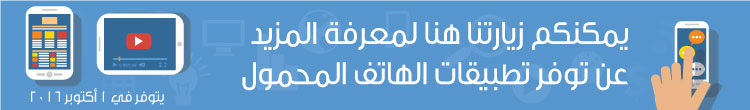بالتأكيد انها الانتفاضة: هذا ما يجب أن تعرفه
بقلم: رمزي بارود
عندما نشرت كتابي "البحث عن جنين" بعد وقت قصير من المجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين في عام 2002، تم سؤالي مرارا وتكرارا من قبل وسائل الإعلام والعديد من القراء عن وصف كلمة "مذبحة" حول ما تصوره إسرائيل على أنها معركة مشروعة ضد معسكر من 'الإرهابيين'.
وكان الهدف من الأسئلة الاستفهام عن نقل رواية من مناقشة بشأن جرائم الحرب المحتملة في نزاع فني حول تطبيق اللغة بالنسبة لهم، اما الأدلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان فكانت لا تهمهم سوى قليلا.
وكثيرا ما يقدم هذا النوع من الاختزال كمقدمة لأي نقاش متعلق بشأن ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي: وصف الأحداث وتحديد استخدام المصطلحات و الاستقطاب عبرالالتفات قليلا إلى الوقائع والسياقات، والتركيز في المقام الأول على المفاهيم والتفسيرات.
وبالتالي، يجب أيضا النظر قليلا لهؤلاء الأفراد نفسهم من الشباب الفلسطيني مثل إسراء عابد (28 عاما) و التي أطلق النار عليها في التاسع من اكتوبر في عافولا - وفادي سمير (19 عاما) الذي قتل على يد الشرطة الإسرائيلية قبل بضعة أيام، لقد كان في الحقيقة في حالة دفاع عن النفس واطلق عليه النار من قبل الشرطة و هو يحمل سكينا. حتى عندما اظهرت أدلة الفيديو ما يخالف الرواية الإسرائيلية الرسمية ، كما هو الحال في معظم الحالات الأخرى فأن الشباب الذي قتل لا يشكل خطرا، ودائما ما يتم قبول الرواية الإسرائيلية الرسمية على أنها حقائق من قبل بعض. إسراء، فادي، وبقية العالم هم من "الإرهابيين" الذين يشكلون خطرا على سلامة المواطنين الإسرائيليين و للأسف كان لا بد من القضاء عليهم نتيجة لذلك.
وقد استخدم المنطق نفسه طوال القرن الماضي، عندما كانت قوات الدفاع الإسرائيلية الحالية تعمل كالميليشيات المسلحة والعصابات المنظمة في فلسطين قبل تطهيرها عرقيا و قبل أن تصبح إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، هذا المنطق طبق في كل سياق ممكن وجدت إسرائيل نفسها فيه حيث زعمت أنها مضطرة لاستخدام القوة ضد "الإرهابيين" الفلسطينيين والعرب، و "الإرهابيين" المحتملين جنبا إلى جنب مع "البنية التحتية للإرهاب ".
أنها ليست على الإطلاق حول نوع من الأسلحة التي تستخدم ضد الفلسطينيين إذا ما وجدت . العنف الإسرائيلي يتعلق إلى حد كبير بتصور إسرائيل نفسها للواقع الذي صممته: أن إسرائيل كونها دولة محاصره كانت تحت التهديد المستمر من قبل الفلسطينيين سواء كانوا يقاومون باستخدام الأسلحة أو الأطفال الذين يلعبون على الشاطئ في غزة . لم يكن هناك انحراف عن المعتاد في تأريخ الخطاب الإسرائيلي الرسمي الذي يفسر ويبرر و يحتفل بوفاة عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مر السنين: الإسرائيليون لا يخطئون أبدا و سياق "العنف" الفلسطيني ليس مطلوبا في كل وقت.
الكثير من مناقشاتنا الحالية بشأن الاحتجاجات في القدس والضفة الغربية، و في الحدود مع قطاع غزة تتركز على الأولويات الإسرائيلية، وليس الحقوق الفلسطينية، بصوره متحيزة بشكل واضح. مرة أخرى، إسرائيل تتحدث عن "الاضطرابات" ومنشأ "الهجمات" من "الأراضي"، كما لو أن الأولوية هي ضمان سلامة المحتلين المسلحين من الجنود والمستوطنين المتطرفين، و امثالهم على حد سواء.
بعقلانية، فإن الدولة ستتحول من "الاضطرابات"، الى المكان "الهادئ" و "الخامد"، عندما يتفق ملايين الفلسطينيين من و يرضون بالإنهزام ، والإذلال، و الإحتلال ، المحاصره والقتل الاعتيادي، أو في بعض الحالات، الأعدام من قبل إسرائيل و الغوغاء اليهودية أو الأحراق حيا، في حين يحتضنون مصيرهم البائس ويستمرون في الحياة كالمعتاد.
وهكذا تحقق العودة إلى الحياة الطبيعية ارتفاع في سعر الدم والعنف الذي احتكرته اسرائيل ، وبينما نادرا ما يشكك في أفعالها وعلى الفلسطينيين بعد ذلك تولي دور الضحية الدائمة، ويمكن لأسيادهم الإسرائيليين أن يستمروا في حراسة نقاط التفتيش العسكرية، وسرقة الأراضي وبناء بعد المزيد من المستوطنات الغير القانونية و التي تنتهك القانون الدولي.
والسؤال المطروح الآن، ألا ينبغي أن تكون الاستفسارات الأساسية حول ما إذا كان بعض الفلسطينيين يحملون السكاكين أم لا، أو حقا يشكل خطرا على سلامة الجنود والمستوطنين المسلحين. بدلا من ذلك، يجب أن تركز بصفة أساسية على فعل عنيف للغاية من الاحتلال العسكري والمستوطنات الغير قانونية في الأراضي الفلسطينية في المقام الأول.
من هذا المنظور فإن شهرالسكين هو، في الواقع، فعل دفاع عن النفس؛ الجدل في ان الرد الإسرائيلي متناسب أم لا مع "العنف" الفلسطيني هو، موضع نقاش تماما.
قلق النفس يأتي مع التعاريف الفنية اللاإنسانية من التجربة الفلسطينية الجماعية.
"لم على العديد من الفلسطينيين أن يقتلوا من اجل قضية استخدام مصطلح 'مجزرة'؟" كان جوابي لمن شكك في استخدامي لهذا المصطلح. وبالمثل، وكم يجب أن يقتل، وكم من الاحتجاجات يتعين تعبئتها وإلى متى "الاضطرابات" الحالية، "الثورة" أو "الاشتباكات" بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تصبح 'الانتفاضة'؟
ولماذا ينبغي حتى أن تسمى "الانتفاضة الثالثة"؟
يصف مازن قمصية ما يحدث في فلسطين باسم "الانتفاضة الـ14. و هو يعرف أفضل، لأنه من ألف الكتاب المتميز، المقاومة الشعبية في فلسطين: تاريخ من الأمل والتمكين. ومع ذلك، أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأقترح أن يكون هناك العديد من الانتفاضات، و أن تستخدم التعاريف التي لها صلة بالخطاب الشعبي للفلسطينيين أنفسهم. الانتفاضات - تنفض - عند تعبئة المجتمعات المحلية الفلسطينية في فلسطين، وعند التوحد وراء الأجندات الفئوية والسياسية وتنفيذ حملة متواصلة من الاحتجاجات والعصيان المدني وغيرها من أشكال المقاومة الشعبية.
يحصل ذلك عندما يتم الوصول إلى نقطة الانهيار، تلك العملية التي لا يتم التصريح عنها عن طريق النشرات الصحفية أو المؤتمرات المتلفزة، ولكن هي غير معلنة، ولكن الى الابد.
على الرغم من حسن النية، البعض يزعمون أن الفلسطينيين ليسوا مستعدين بعد لانتفاضة ثالثة، كما لو الانتفاضات
الفلسطينية هي عملية مدروسة تنفذ بعد الكثير من المداولات والمساومات الاستراتيجية. لا شيء يمكن أن يكون أبعد من ذلك عن الحقيقة.
ومن الأمثلة على ذلك الانتفاضة في 1936 ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني في فلسطين. نظمت في البداية من قبل الأحزاب العربية الفلسطينية والتي صدر ضدهم في الغالب أحكام من قبل حكومة الانتداب البريطاني نفسه. ولكن عندما بدأ الفلاحين الفقراء وغير المتعلمين إلى حد كبير بالاستشعار عن بعد أن قيادتهم كان يجري تحييدهم - كما هو الحال اليوم - أنهم يعملون خارج حدود السياسة، بدأ التمرد و استمر لمدة ثلاث سنوات.
الفلاحين ذلك الحين كما كان الحال دائما حملوا العبء الأكبر من العنف البريطاني والصهيوني لأنهم عملوا في جماعات حاشدة حالفها الحظ بما يكفي للإشتعال ، لقد تعرضوا للتعذيب وأعدموا: فرحان السعدي، عز الدين القسام، محمد جمجوم وفؤاد حجازي من بين قادة العديد من ذلك الجيل.
وكانت هذه السيناريوهات في إعادة مستمرة منذ ذلك الحين، ومع كل الانتفاضة، الثمن المدفوع من الدم يبدو أنه في تزايد مستمر. بعد أكثر من انتفاضتين لا مفر منهما، سواء استمر لأسبوع أو ثلاثة أو سبع سنوات، المظالم الجماعية التي يعاني منها الفلسطينيون تبقى القاسم المشترك بين الأجيال المتعاقبة من الفلاحين وذريتهم من اللاجئين.
ما يحدث اليوم هو الانتفاضة، ولكن ليس من الضروري تخصيص رقم لذلك، التعبئة الشعبية لا تتبع دائما منطق منمق من قبل بعض منا. وكان معظم هؤلاء الذين يقودون الانتفاضة الحالية من الأطفال أو حتى لم يكونوا قد ولدوا عندما بدأت انتفاضة الأقصى في عام 2000؛ انهم بالتأكيد لم يعيشوا عندما انفجرت الانتفاضة في عام 1987. وفي الواقع، قد يكون الكثير غافلون عن تفاصيل الانتفاضة الأصلية في عام 1936.
نما هذا الجيل مضطهدا، ومقيدا ومقهور، على خلاف 'عملية السلام' المضللة لفترات طويلة و في مفارقة غريبة بين الخيال والواقع. انهم يحتجون لأنهم يتعرضون لتجربة الإذلال اليومي، و يحتملون العنف المتواصل من الاحتلال.
وعلاوة على ذلك، فإنهم يشعرون شعورا كليا بالخيانة من قبل قيادتهم، الفاسدة و المحيدة لذلك هم من الثوار، ومحاولة حشد ودعم تمردهم لطالما ما في وسعها، لأنهم لا يملكون أي أفق من الأمل خارج نطاق اعمالهم.
دعونا لا نتورط في التفاصيل والتعاريف المفروضة و الأرقام. هذه هي الانتفاضة الفلسطينية، حتى لو كانت ستنتهي اليوم . ما يهم حقا هو كيف نرد على المناشدات من هذا الجيل المظلوم. و كيف سنستمر في تعيين أهمية أكبر لسلامة المحتل المسلح على حقوق أمة مثقلة من المظلومين؟
 العربي الديمقراطي The Latest From The Arab World
العربي الديمقراطي The Latest From The Arab World